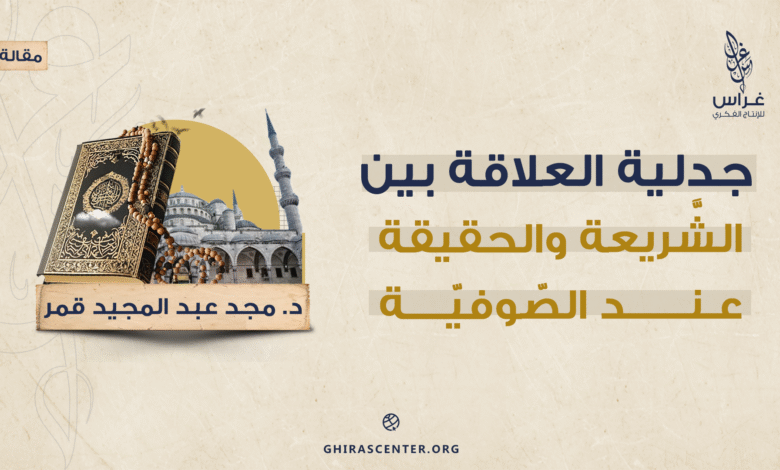
جدلية العلاقة بين الشَّريعة والحقيقة عند الصّوفيّة
الكاتبة: د. مجد عبد المجيد قمر
إن منظومة الدين الشاملة الإسلام والإيمان والإحسان، اقتضت أن تكون العلاقة بين هذه الجوانب علاقة متكاملة، لا يتم أحدها دون الآخر؛ إذ تشكل فيما بينها وحدة مترابطة ومتكاملة، وفق نسق معرفي جامع، فالأصل في الشريعة أنها واحدة؛ والتمييزُ بين علم التصوف من جهة وبين علم الفقه الباحث في الأحكام العملية الفرعية، وبينه وبين علم الكلام الباحث في الاعتقاديات، هو تمييز تصنيفي فقط، أما في نفس الأمر فعلم الفقه يستند إلى علم الكلام استناد الفرع على الأصل، وعلم التصوف يكمِّل علمَ الكلام وعلم الفقه، وعليه فلا بد أن يكون الصوفي المتحقق عالماً بالكتاب والسنة، ملمَّاً بأمور الفقه والتوحيد.
وانفصال هذه العلوم الثلاثة –أعني: الفقهَ والكلامَ والتصوفَ – بدأ ظهوره في القرن الثالث الهجري وما بعده، نتيجة التخصص العلمي الدقيق، حيث سار كل علم في مساره الخاص، أما قبل ذلك: فكان اسم الفقه يطلق ليس فقط على العمليات، بل على الاعتقاديات والأخلاق([1])، ومما يدل على ذلك ما ذكره صاحب (كشاف اصطلاحات الفنون)، “علم الفقه: ويسمى هو وعلم أصول الفقه بعلم الدراية أيضاً، […] وهو: معرفة النفس ما لها وما عليها، -هكذا نقل عن أبي حنيفة-، وما لها وما عليها: يتناول الاعتقادات كوجوب الإيمان ونحوه، والوجدانيات؛ أي: الأخلاق الباطنة والملكات النفسانية، والعمليات: كالصوم والصلاة والبيع ونحوها، فمعرفة ما لها وما عليها من الاعتقاديات: هي علم الكلام، ومعرفة ما لها وما عليها من الوجدانيات: هي علم الأخلاق والتصوف…. ومعرفة ما لها وما عليها من العمليات: هي الفقه المصطلح”([2]).
ويؤكد إمام الصوفية زرُّوق هذا المعنى فيقول: “لا تصوف إلا بفقه؛ إذ لا تعرف أحكام الله الظاهرة إلا منه، ولا فقه إلا بتصوف؛ إذ لا عمل إلا بصدق وتوجه. ولا هما إلا بإيمان؛ إذ لا يصح واحد منهما دونه. فلزم الجميع لتلازمها في الحكم، كتلازم الأجسام للأرواح، ولا وجود لها إلا فيها، كما لا حياة لها إلا بها، فافهم!”([3]).
هذا هو الأصل الذي تُفهم من خلاله جوانب الدين المتكاملة، وهو الأصل الذي وجد في خير القرون، وكل جدل وُجد بعد ذلك بين الصوفية والفقهاء إنما جاء في سياق قراءة أحد الفكرين للآخر قراءة قاصرة، أو على وجود فئات غير منضبطة انتسبت للتصوف ورسّخت هذه الصورة الخلافية عنه.
أصل مصطلحي الشريعة والحقيقة عند الصوفية
لأهل هذا الفن اصطلاحاتهم التي درجوا عليها، وبنوا عليها موروثهم الفكري، ومنها: الشريعة والطريقة والحقيقة، المتصلة اتصالاً وثيقاً بالحديث عن علاقة العلم الظاهر بالعلم بالباطن:
فالشريعة كما يعرفها الصوفية: تكليف الظواهر، والطريقة: تصفية الضمائر، والحقيقة: شهود الحق في تجليات المظاهر([4])، وقد أضيف مصطلح الطريقة، كسبيل يصل بين الشريعة والحقيقة، وهو ما يبينه الشيخ زكريا الأنصاري -في شرحه على رسالة الشيخ أرسلان- فيقول: “واعلم أن لهم شريعة وهي: أن تعبده تعالى، وطريقة: وهي أن تقصده بالعلم والعمل، وحقيقة: وهي أن تشهده بنور استودعه في سويداء القلب”([5]).
ومصداق ذلك قوله لحارثة: «يا حارثةُ.. كيفَ أصبحتَ؟» قالَ: أصبحْتُ مؤمناً باللهِ حقاً.. فقالَ: «لكلِّ حقٍّ حقيقةٌ، فما حقيقةُ إيمانِكَ؟» فقلتُ: عزفَتْ نفسِي عن الدنيا، فأسهرتُ ليلي، وأظمأتُ نهارِي، وكأنِّي أنظرُ إلى عرشِ ربِّي بارزاً، وإلى أهلِ الجنةِ يتزاورونَ، وإلى أهلِ النارِ يتعاورونَ، فقالَ عليهِ الصَّلاة والسَّلامُ: «عبدٌ نوَّر اللهُ الإيمانَ في قلبِهِ، فالزَم”([6]).
ولعل القومَ اصطلحوا علمهم بهذا الاسم أخذاً من هذا الحديث الشريف، كما بين السّيوطي بقوله: “يظهر لي أن أهل هذا الشأن إنما سَمَّوا علمهم علم الحقيقة؛ أخذاً من لفظ الحقيقة في هذا الحديث، وقد ظهر لي أنَّ نسبة علم الحقيقة إلى علم الشريعة، كنسبة علم المعاني والبيان إلى علم النحو، فهو سرُّه ومبنيٌّ عليه، فمن أراد الخوض في علم الحقيقة من غير أن يعلم الشريعة: فهو من الجاهلين، ولا يحصل على شيء، كما أن من أراد الخوض في أسرار علم المعاني والبيان من غير أن يُحكم النحو: فهو يخبط خبط عشواء”([7]). وهذا التأصيل يبين أهمية العلاقة بين العلمين عندهم، وهو ما أكد عليه الصوفية باستمرار في مؤلفاتهم.
لا يكون عارفاً بالله من يكون جاهلاً بأحكامه وأوامره، غير قائم بها على حدود السنن
العلاقة بين الشّريعة والحقيقة
لا يمكن المرور على كتاب من أمهات كتب التصوف، دون التعريج على ذكر معنى الحقيقة والشريعة، أو العلاقة بينهما، إما لكثرة الجدل الحاصل في هذا الباب، أو لكونها اصطلاحات أساسية استعملها أهل هذا الفن، وعلى سبيل المثال: يذكر أبو عبد الرحمن السلمي في (رسائله): أكثر من عشرة أقوال في العلاقة بين الشريعة والحقيقة، منها قوله: “والتحقيق في الشريعة هو الحقيقة، والترسُّم بالأمر هو الشريعة، والإخلاص في الأمر هو الحقيقة”([8])، وعليه فلا فرق بين الشريعة والحقيقة، فالشريعة أن تعبده، والحقيقة أن تشهده، يؤيد ذلك أئمة التصوف أنفسهم عبر تاريخهم: فيقول أبو تراب النَّخْشَبي أحد صوفية القرن الثالث الهجري، “لا يكون عارفاً بالله من يكون جاهلاً بأحكامه وأوامره، غير قائم بها على حدود السنن”([9])، أما العز بن عبد السلام من علماء القرن السابع الهجري فيقول: “وليست الحقيقة خارجة عن الشريعة، بل الشريعة طافحة بإصلاح القلوب بالمعارف والأحوال والعزوم والنيات، وغير ذلك مما ذكرناه من أعمال القلوب، فمعرفة أحكام الظواهر: معرفة لجلِّ الشرع، ومعرفة أحكام البواطن: معرفة لدقِّ الشرع، ولا ينكر شيئاً منهما إلا كافر أو فاجر”([10])، بينما يبين الشيخ عبد الغني النابلسي –وهو من علماء وصوفية القرن الثاني عشر- أن البيان الإلهي متكامل في حقيقته، وإلا فأي فصل بين جوانبه هو قصور فهم له، فيقول: “والحقيقة: أي حقيقة الشريعة يعني حقيقة البيان الإلهي، على ما هو عليه لا على حسب فهم القاصرين له، فلا فرق بينها وبين الشريعة إلا بحسب كمال الفهم وقصوره”([11]).
ويذكر لنا السلمي في هذا الصدد جملة من الأقوال مدارها على إسقاط التكليف عند معرفة الله تعالى، ويرد عليها واحدة واحدة، ثم يقول: “وأما قوله: إذا عرف الله سقط عنه الأمر والنهي: فإن كان يعرف ربه آمراً وناهياً لعبيده، ويعرف نفسه عبداً: فليس يسقط عنه حكم العبودية، وإن لم يكن يعرفه آمراً وناهياً: فما هو بعارف”([12]).
فسبيل التحقق بالتصوف عند القوم بابه: تعلم العلوم الشرعية؛ إذ هي سبيل العبادة، وهو ما يؤكده شيخ الشاذلية الدرقاوية: العربيُّ الدرقاوي في (رسائله) إذ يقول: “فإن شئتَ أن تطوى لك الطريق، وتحصل في ساعة على التحقيق، فعليك بالواجبات، بما تأكد من نوافل الخيرات، وتعلم من علم الظاهر ما لابد منه؛ إذ لا يعبد ربنا إلا به…”([13]).
فهذه جملة من أقوال الصوفية في أزمنة متفاوتة، وكلامهم عن أهمية علم الشريعة وضرورة تحصيل العلم الشرعي لسالك طريق القوم، لم يكن مجرد فكر مبثوث في كتبهم وحسب، فإن الرجال المتحققين منهم كانوا علماء شريعة وحقيقة، فالجنيد مثلاً: كان فقيهاً في حلقة أستاذه وهو ابن عشرين سنة، وكان العلماء يحضرون مجلسه؛ لتقريره، والفلاسفة يحضرون مجلسه؛ لدقة نظره، أما المتكلمون فكانوا يحضرون مجلسه؛ لتحققه، والصوفية؛ لإشاراته وحقائقه.
ويكفي أن يتصفح الباحث (رسائل الجنيد) ليعرف أنه أمام عالم من أئمة علماء المسلمين، ولم يكن بدَعاً من الصوفية في ذلك؛ فأستاذه المحاسبي كان من الصوفية المتحققين أيضاً، ومؤلفاته كثيرة في مستوى سامٍ، حتى أصبحت من المصادر الرئيسة للإمام الغزالي([14]).
على سبيل الختام
لقد فهم هؤلاء العلماء العاملين حقيقة التكامل بين علوم الشرع، فخلدوا اسمهم في تاريخ التجديد الديني، لتصبح الحاجة ملحة على كل دعاة الإصلاح والتجديد لتدقيق النظر بين العلوم الإسلامية وفهم المقصد الشرعي منها، للوصول إلى بناء نسقي فاعل ومتكامل بينها، يتجلى فيه حديث جبريل الذي رسخ مفهوم التكامل بين الإسلام والإيمان والإحسان في أوضح صورة.
([1]) انظر: مدخل إلى التصوف، أبو الوفا التفتازاني، (ص/16).
([3]) قواعد التصوف، القاعدة (3)، (ص/15).
([4]) انظر: معراج التشوف، ابن عجيبة، (ص/ 36).
([6]) أخرجه البزار في مسنده عن سيدنا أنس t، مسند أبي حمزة أنس بن مالك، برقم (6948)، (13/333). قال في (مجمع الزوائد): “رواه البزار، وفيه يوسف بن عطية لا يحتج به” انظر: الهيثمي، باب في حقيقة الإيمان وكماله، (1/ 57).
([7]) تأييد الحقيقة العلية، (ص/21).
([8]) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق، عن سيدنا عمار بن ياسر، بلفظ قريب، باب: فضل ذكر الله عز وجل، برقم (1301)، (1/ 495).
([9]) نقلاً عن أبي عبد الرحمن السلمي في رسالته في معرفة الله، ضمن مجموع رسائل أبي عبد الرحمن السلمي، (ص/256).
([10]) قواعد الأحكام، (2/ 179).
([11]) شرح رسالة الشيخ أرسلان، (ص/98).
([12]) رسالة في معرفة الله، ضمن مجموع رسائل أبي عبد الرحمن السلمي، (ص/356- 359).
([13]) انظر: بشور الهدية في مذهب الصوفية، وهي مجموعة رسائل العربي الدرقاوي، (ص/33).
([14]) انظر: موقف الإسلام من الفن والعلم، عبد الحليم محمود، (ص/137- 144).



