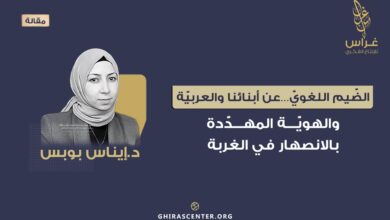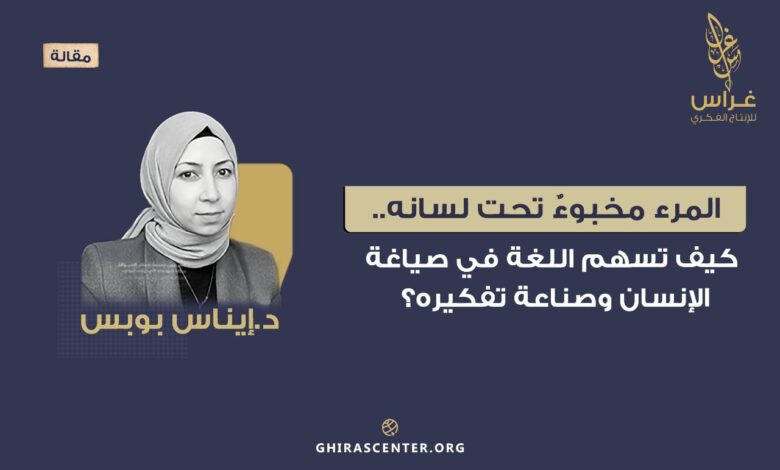
“المرء مخبوءٌ تحت لسانه” – كيف تسهم اللغة في صياغة الإنسان وصناعة تفكيره؟
هل جرَّبت أن تُحصي عدد الكلمات التي تنطق بها كلّ يوم؟
بعض النّاس يُحصون عدد خطواتهم في اتجاههم نحو تحقيق معدّل يضمن للمرء جسداً قوياً وصحة جيدة، لكن ماذا لو قرّرنا أن نعدّ كلماتنا! نستخدم اللغة في تواصلنا مع الآخر عائلةً وأصدقاء وزملاء عمل، ونستعملها للتّواصل مع النّاس عامّة لتحقيق أغراض متنوّعة ومنافع مختلفة، فهي الوسيلة التي نعبّر بها عن عواطفنا واحتياجاتنا، وننشئ بوساطتها علاقاتنا مع الآخرين، وكثيراً ما يغفل المرء عن كون اللغة هي الأداة التي ترسم صورته لدى نفسه وعند الآخرين، لذلك لا يُعير لِلُغته وللألفاظ والأساليب اللغوية التي يستعملها في كلامه الاهتمام الذي تستحقّه.
قد يتعجب القارئ من قولي إن اللغة هي الأداة التي ترسم صورة الإنسان لدى نفسه! نعم، فالمرء في نجواه مع نفسه يستخدم لغته وأسلوبه والألفاظ التي اعتاد أن يستعملها ويوظفها في عباراته وحديثه، ويتأثر بها وينفعل معها، فإن كان حديثه مع نفسه إيجابياً انعكس ذلك على سلوكه ومزاجه بالإيجاب والإشراق، وإن كان سلبياً لأسباب مختلفة فإنه يعكر مزاجه وينعكس على سلوكه بالحدّة والشعور بالضيق والانزعاج.
دعني أسألك: لو أُتيح لك أن تسمع حديثك مع نفسك أو مع الآخرين بوصفك طرفاً ثالثاً، فهل سيروق لك أسلوبك؟
إنّ اللغة التي نستعملها والألفاظ التي اعتدنا الاتّكاء عليها في أحاديثنا تشكّل ذواتنا، وتعكس صورنا الحقيقية، وتؤثر في صياغتنا لأنفسنا، وفي نظرتنا إليها، وفي نظرة الآخر إلينا. ومن هذا المنطلق يمكننا أن نعدّ اللغة مفتاحاً سحرياً لبوابة النجاح في تكوين النفس وإنشاء العلاقات.
وقد قيل في الأثر: “إن البلاء موكل بالمنطق”، ودرج على لسان العامة قولهم: “القدر موكل بالمنطق”، وقولهم: “المَلافِظُ سَعدٌ”، وجاء في المقاصد الحسنة أنّ ابن الجوزي أورد هذا الحديث في الموضوعات، ولا يحسن الحكم عليه بذلك، إذ يؤيد معناه قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للرجل عاده في مرضه فواساه بقوله: لا بأس طهور إن شاء الله، فقال له الرجل: بل هي حمى حتى تفور علَى شيخٍ كَبِيرٍ كَيْما تُزِيرَهُ القُبُورَ، فردَّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. والمقصود من ذلك كما جاء في قول الشاعر:
لا تَنطِقَن بِما كَرهتَ فَرُبَّما … نَطَقَ اللِّسانُ بِحادثٍ فَيَكونُ
ولذا على المرء أن يتخيّر كلماته حين يحدث نفسه، وينتقي منها ما يليق حين يحدث غيره، وأن يعلم أن التحدث عادة، فإنْ عَوَّدَ الإنسانُ نفسَه جميلَ الكلام أَلِفَه حتّى صار جزءاً منه، وإنْ عَوّدَها الاعتباط في الكلام وانتهج فوضى الألفاظ في تعابيره تَعِسَ وأَتعَسَ مَن حَوله. وفي ذلك قال الشّافعي رحمه الله:
احفَظْ لِسانَكَ أيُّها الإنسانُ
لا يَلدَغنّكَ إنّه ثُعبانُ
كم في المَقابرِ مِن قَتيلِ لِسانِه
كانَت تَهابُ لقاءَه الشُّجعانُ
من لم يتقن لغته الأم يتزعزع انتماؤه الحقيقيّ ويكون أسيراً لأساليب الآخرين في النظر إلى المسائل ومحاكمتها
كما أنّ الكلمة مرآة العقل، وهي معيار السّامع في الحكم على عقل المتحدِّث ومكانته، فلعلك ترى الرجل مَهيبَ الطّلعة فيعجبك، حتى إذا سمعت كلامه زالت هيبته من نفسك وسقط من عينك، ولعلك لا تعبأ برجل بسيط رثّ الهيئة حتى إذا سمعت حديثه ومَنطقَه دخل نفسك بغير استئذان وعَلَت مَكانتُه عندك، ويشهد لذلك قول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “أظلُّ أهاب الرجل حتى يتكلَّم، فإن تكلَّم سقط من عيني، أو رفع نفسه عندي”، وكذلك يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: “المرء مخبوءٌ تحت لسانه”، ومن ذلك العبارة الشهيرة التي تُنسب إلى الفيلسوف اليوناني سقراط: “تكلَّمْ حتى أراك”.
هل للغة تأثيرُ في تفكيرِ الإنسان ومَنطِقِه في مُحاكمة الأمور؟
أجرت جامعة ستانفورد في كاليفورنيا دراسة مقارنة بين متحدثي اللغات المختلفة، وتوصلت إلى أن المتحدثين باللغة اليابانية والإسبانية يُركّزون حين يَروُون قِصّة ما على الحَدَثِ نفسه، في حين يُركّز المتحدثون باللّغة الإنكليزية في أثناء قَصِّ الحكاية نفسها على الأسباب. وهذا يعكس اختلاف أساليب التفكير وتباين طرق معالجة الأمور بالنظر إلى الأحداث والوقائع، وتربط الدّراسة هذا الاختلاف بتأثير منطق اللغة على المتحدثين بها، فلكلِّ لغةٍ مَنطقٌ ومَنهجٌ تفكيريّ خاصّ بها.
ويأخذنا هذا الأمر إلى فكرتين اثنتين؛ الأولى أنّ من أتقن أكثر من لغة يستطيع أن ينظر إلى أيّ مسألة من زوايا متعددة لا من زاوية واحدة، وهذا يقتضي رؤية أشمل وأوسع وأعمق للمسائل؛ والثانية وهي الأهم أنّ من لم يتقن لغته الأم يتزعزع انتماؤه الحقيقيّ ويكون أسيراً لأساليب الآخرين في النظر إلى المسائل ومحاكمتها، فإن كان عربياً بالعرق والانتماء ولا يتقن لغتنا العربية كما يليق بها سيكون أعجميّ التفكير غريب المنطق، وسيُشكِّل مثالاً حياً لأحد مظاهر الاستلاب للغرب وفقدان الاستقلالية في الفكر وتكوين الشخصيّة. ولئن شَعَرَ المتنبي أنّه غريب الوجه واللسان وهو في شعب بوان، إذ قال:
مَغَاني الشِّعْبِ طيباً في المَغَاني
بمَنزِلَة الرّبيعِ منَ الزّمَانِ
وَلَكِنّ الفَتى العَرَبي فِيها
غَرِيبُ الوَجهِ وَاليَدِ وَاللّسَانِ
فإنّ الفتى العربيّ الذي يفقد ارتباطه بلغته اليوم، سيكون غريب العقل والفكر والمنطق بين أبناء أُمّته. وهذا التفصيل يقودنا للحديث عن جدليّة العلاقة بين اللّغة والتفكير.
جدليّة العلاقة بين اللُّغة والتَّفكير
بين اللُّغة والتّفكير علاقة جَدليّة شغلت كثيراً من المهتمّين والباحثين والفلاسفة واللّغويين، فانقسموا في آرائهم إلى فرق عدة، وبرز في هذا النقاش فريقان؛ الأول يعتقد بانفصال الفكر عن اللغة وعجز اللغة عن الإحاطة بأفكار الإنسان، والثاني يذهب إلى اتصالهما لأنّ اللّغة أداة التفكير ووسيلة الإنسان إليه.
يطالعنا في الفريق الأول ديكارت الذي يقول إن تفكير الإنسان لا يتوقف، في حين يستطيع التحكم بلغته وإيقافها، ويدل على ذلك توقف الإنسان في أثناء الكتابة أحياناً للبحث عن مفردات تعبر عن أفكاره وتفيها حقها، وشعور المرء أحياناً بقصور لغته عن التعبير عن عواطفه وأفكاره فيلجأ إلى أنواع الفنون المختلفة من رسم ونحت وموسيقا وغير ذلك، ولعل عبارة برغسون الآتية تعدّ أفضل تعبير عن هذه الفكرة، إذ قال: “الفكر ذاتي فردي، واللغة موضوعية واجتماعية”.
وفي الفريق الثاني يطالعنا كل من هيجل وسوسير اللذين قالا بسير اللغة مع التفكير في خطين متوازيين، فكلاهما مكتسب، وللعائلة والبيئة المحيطة دور كبير في كيفية اكتسابهما والتعامل معهما، وبناء على ذلك فإن اللغة تسير جنباً إلى جنب مع التفكير، وتسبقه لفظاً إلى عقل الطفل في أثناء مراحل التعلّم والتعرف إلى الألفاظ بوصفها الدّوال إلى تشير إلى المفاهيم والمدلولات الحسّيّة من حوله. ويعبّر هيجل عن علاقة اللغة بالتفكير بقوله: “الكلمة تمنح للفكرة وجودها الحقيقي والأسمى”. أما في الرد على القائلين بعجز اللغة عن التعبير عن فكرة ما، فإننا نقول: إن ذلك يدل على أن الفكرة ما تزال ضبابية وغير واضحة في ذهب المتكلم، ولا علاقة لعجز اللغة فما هي إلا أداة يُطوّعها صاحبُها وفقاً لملكاته اللغوية وقدرته الخطابية.
فما المرء إلا حصيلة فكره ولغته، إذا ما عُني بأحدهما ظهر نتاج ذلك في الآخر، فاللّغة رداء الفكر وزينته. وخلاصة القول: إن ذكاء الإنسان واتقاد فكره وارتقاء نفسه وعلو همته يظهر في لغته وأسلوبه في الحديث
هيمنة اللّغة المُتداولة وتأثير الثّراء اللّغويّ في تفكير الإنسان
إن لغة المرء عبارة عن انتقاءات وتفضيلات اكتسبها من عائلته ومحيطه، فالغلبة عند اختيار الألفاظ والمفردات والتراكيب اللغوية تكون للأكثر استعمالاً وشيوعاً وتردّداً على الأسماع، وسواء أكانت الأفكار بسيطة أو عميقة فإن المرء يميل إلى استعمال ما يألفه من مفردات اللغة، وهي بِدَورِها تشكّل صورته الذهنية لدى نفسه أولاً ولدى الآخرين في المرتبة الثانية، فإن كانت ألفاظه فصيحة مثقفة عميقة شعر بها عنواناً لشخصيته، وفرض بها صورة خاصة عن نفسه في محيطه ومجتمعه.
ولعلّ حرص العرب في سابق الأزمان على إرسال أولادهم إلى البادية لاكتساب فصاحة اللسان يردف هذه الأفكار، فما من أحدٍ لا يريد بناء شخصية قوية لطفله، وما من أحد لا يرغب باكتساب طفله لغة سليمة فصيحة في مجتمع يقوم على التواصل اللغوي طوال الوقت، سواء أكانت اللغة منطوقة أو مكتوبة كما في عصرنا الحالي وفقاً للتواصل الحثيث كتابياً في العمل والحياة عامة عبر الإنترنت. وقد كانوا يفعلون ذلك في مراحل مبكرة من عمر الطفل لما في “هواء البادية من الصفاء، وما في أخلاقها من السلامة والاعتدال، والبعد عن مفاسد المدنية، ولأنّ لغة البادية سليمة أصيلة”. وفي هذا الأمر دلالة واضحة على أن من يتقن لغة ما فإنّه يتقن منطق أهلها ويكتسب أنماط التفكير السائدة لديهم في مُقاربة المسائل ومحاكمتها، وهذا يعني بالضرورة أن من يتقن أكثر من لغة يحمل بين جنبيه أكثر من روح إذا جاز التعبير.
وقد قيل قديماً: “من صحّ لسانه بالعربية صحّ عقله”، فسلامة اللغة وقوة الأسلوب وثراء الذخيرة اللغوية وغزارتها لدى المرء تنعكس انعكاساً إيجابياً على رجاحة عقله وسعة تفكيره وقدرته على التعبير عن مراده في أي جانب من جوانب الحياة، كما أنها تمثل رافداً لاتساع آفاق النظر والاعتدال والإنصاف في موازنة الأمور ومعالجتها، وتوفر للإنسان قدرة مميزة على التأثير في الناس من حوله، والعكس صحيح.
وعن ارتباط اللغة بذكاء الإنسان يقول تشومسكي: “إن اللغة مؤشر على الذكاء، وهي مرآة العقل ووسيلة للتعبير عن المعاني والمشاعر والتّفاهم مع الآخرين”. ويؤكد هارلوك أنّ النّموّ اللّغوي عند الأطفال يعدّ أحد المظاهر الأساسية التي يعتمد عليها عند قياس النمو العقلي والنفسي والانفعالي والاجتماعي للطفل، فمستوى إتقان اللغة يدلّ على درجة النضج العقلي. ناهيك من أنّ سلامة الأسلوب اللغوي وسلاسته تدل على رجاحة العقل وقدرة المرء على ترتيب أفكاره وتنظيمها، فالفكـر يصنـع اللغـة واللغة ترفد الفكر.
العامّيّة ومعضلة تعلّم الفصحى وممارستها
يعاني الإنسان العربي من أزمة لغوية تتمثل بتأرجحه بين الفصحى والعامية، فالأولى هي اللغة الرسمية وهي لغة الفكر والثقافة التي يجدها في الكتب وعلى مقاعد الدراسة ويواجهها عند تسيير المعاملات الرسمية في الدوائر الحكومية، والثانية هي أداته للتواصل في حياته اليومية مع محيطه القريب والبعيد في البيت والشارع، ومن المؤسف حقيقة أن العامّيّة تبدو أقرب للنّفوس عامّة، وتجد كثيراً من العرب يقولون إنهم أكثر قدرة على التعبير عن مرادهم حين يتكلمون بلهجاتهم المحلية، ويزيد الطّين بِلّة أولئك المتثاقفون الذين يقولون إن العربية تقصر عن التعبير عن بعض المشاعر والانفعالات والأفكار، في حين يجدون ضالتهم في غيرها من اللغات! والحقيقة أن رؤاهم قاصرة وأساسهم اللغوي ضعيف وانتماؤهم للأُمّة أضعف وإن بدا للناس غير ذلك، لأننا لو عمدنا إلى استعمال الفصحى في حياتنا اليومية لَدَرَجَت على أَلسِنتنا كثيرٌ من الألفاظ المُهمَلة والمَتروكة بفعل الاستسهال والميول إلى الرائج والمعروف والمتعارف عليه بين الناس في لغة الشارع إذا جاز لنا التعبير. فما المرء إلا حصيلة فكره ولغته، إذا ما عُني بأحدهما ظهر نتاج ذلك في الآخر، فاللّغة رداء الفكر وزينته. وخلاصة القول: إن ذكاء الإنسان واتقاد فكره وارتقاء نفسه وعلو همته يظهر في لغته وأسلوبه في الحديث، ورجاحة عقله تبدو في قدرته على ترتيب الأفكار والتعبير عنها بسهولة وسلاسة، فمن أراد أن يهذّب فكره فعليه أن يُقويّ لغته ويُثريها بالجميل النافع ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.