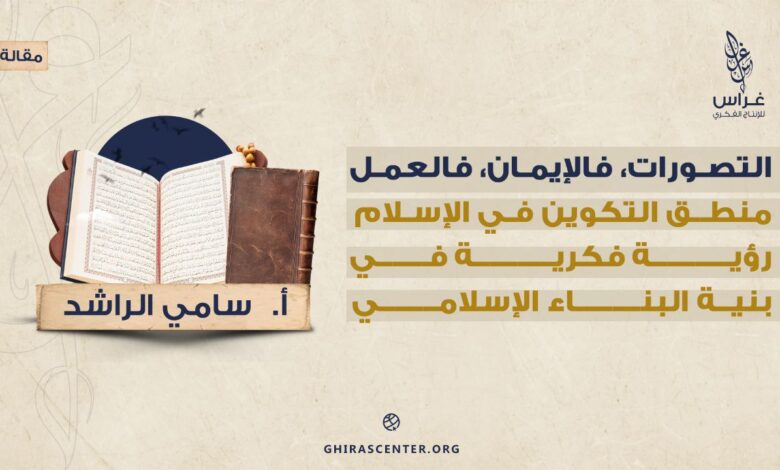
التصورات، فالإيمان، فالعمل: منطق التكوين في الإسلام رؤية فكرية في بنية البناء الإسلامي
أ. سامي الراشد
لماذا يبدأ الإسلام من العقل لا من السلوك؟
الإسلام لم يأتِ ليغيّر سلوك الإنسان جزئيًا، بل جاء ليُعيد صياغة الإنسان من الداخل. ولهذا لم يكن أول خطاب الوحي أمرًا بالصلاة أو الصيام، بل أمرًا بالقراءة: {اقْرَأْ} [العلق: 1] لأن الفكرة قبل الفعل، والعقيدة قبل التشريع، والوعي قبل الحركة. وهذا هو منطق الإسلام في البناء الحضاري: زرع التصورات الصحيحة، فترسيخ الإيمان، ثم توليد العمل الصالح كنتيجة حتمية لهذا التكوين.
أولًا: التصور هو البذرة الأولى لكل إيمان وعمل
ما نؤمن به، وما نفعله، هو انعكاس لما نتصوره عن الله، عن الإنسان، عن الوجود، عن الحياة والموت، عن الخير والشر.
ولهذا، فإن أول ما غرسه النبي ﷺ في مكة كان تصورًا جديدًا للعالم:
• أن الله واحد لا يُشرك به
• أن الإنسان مخلوق مُكرم
• أن الموت بداية لا نهاية
• أن الحساب آتٍ لا محالة
يقول ابن القيم رحمه الله:
“فصل الدين عن تصوراته وقضاياه هو فصل للإسلام عن روحه، وجعله أجوف لا يحمل تغييرًا ولا هداية” (مفتاح دار السعادة) ولذلك ركز القرآن المكي على بناء هذه التصورات، أكثر من التشريعات. بل لم تنزل فريضة الصلاة إلا بعد سنوات، لأن الإيمان كان يُبنى على تصور واضح للربوبية والمعاد.
ثانيًا: الإيمان ثمرة التصور السليم
حين تستقر التصورات في النفس، تتحول إلى إيمان راسخ، لا إلى مجرد قناعة عقلية.
التصور يفكر، والإيمان يُصدّق، ويطمئن، ويتعلق.
قال الله تعالى:
{أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ} [الزمر: 22]وهذا النور لا يأتي إلا بعد أن تتهيأ النفس بفهم وتصور سليم.
وقال النبي ﷺ لوفد عبد القيس:
“آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله…” (رواه البخاري ومسلم) فالإيمان في الإسلام ليس قبولًا ذهنيًا، بل تفاعل قلبي وعقلي ونفسي مع التصور الكامل للحياة.
وفي زمان تتعدد فيه مشاريع التغيير، وتتنافس فيه الأيديولوجيات، يبقى الإسلام هو المشروع الوحيد الذي يبدأ من الداخل إلى الخارج، من التصور إلى الفعل، لا العكس.
ثالثًا: العمل ثمرة حتمية للإيمان الصادق
في القرآن، الإيمان والعمل مقترنان، لكن الإيمان دائمًا يسبق العمل، لأنه مولده: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ…} [العصر، الكهف، البقرة، وغيرها] وهذا يدل على أن العمل الصالح ليس أمرًا خارجيًا يُضاف، بل ينبع من الداخل. هو نتاج لما فهمه الإنسان وآمن به.
قال الحسن البصري:
“ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدّقه العمل”
(رواه ابن أبي شيبة، وسنده صحيح)
فمن آمن بالآخرة حقًا، لا يمكن أن يعيش في الدنيا كأنها كل شيء.
ومن تصوّر الله عالمًا بالسر والنجوى، لا يسرق، ولا يخون، ولا يظلم.
رابعًا: المجتمع الإسلامي يولد من هذه الثلاثية
تصورات صحيحة → إيمان حيّ → عمل صالح = مجتمع سليم
هذه المعادلة هي مفتاح بناء الأمة، ومن دونها يصبح العمل هشًا، متقلبًا، غير منتج.
حين غيّر النبي ﷺ التصورات في مكة، بدأ الناس يرون أنفسهم عبيدًا لله لا للأصنام، يرون الظلم قبيحًا لا معتادًا، يرون الدنيا دار عبور لا مقام. فولد من ذلك جيل لا يُقهر، كانت هويته متجانسة بين الفكر والعقيدة والسلوك.
خامسًا: اختلال الثلاثية هو سر الفشل
حين يُختزل الدين في العمل فقط، بلا تصور ولا إيمان، ينتج نفاق سلوكي.
وحين نزرع الإيمان في بيئة تصورات خاطئة (عن الله أو الإنسان)، يتحول إلى خرافة أو تشدد.
وحين نبني التصورات دون ترجمتها إلى إيمان، تظل أفكارًا معلقة في الذهن لا تغير الواقع.
ولهذا قال الله: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا} [الكهف: 110] وجمع بين الرؤية والإيمان والعمل في وحدة تكوينية واحدة.
خاتمة: نحو مشروع إنساني يبدأ من الفكرة
إن مشروع الإسلام لتغيير الإنسان يبدأ من تحرير العقل بالتوحيد، ثم تحريك القلب بالإيمان، ثم دفع الجوارح بالعمل الصالح.
• التصور هو البوصلة
• الإيمان هو الوقود
• العمل هو السير نحو الله، ونحو الإصلاح في الأرض
قال الإمام الغزالي: “من ظن أنه يُصلح قلبه دون أن يُصلح فكره، فقد أراد أن يبني بيتًا دون أساس” (إحياء علوم الدين)
وفي زمان تتعدد فيه مشاريع التغيير، وتتنافس فيه الأيديولوجيات، يبقى الإسلام هو المشروع الوحيد الذي يبدأ من الداخل إلى الخارج، من التصور إلى الفعل، لا العكس.



