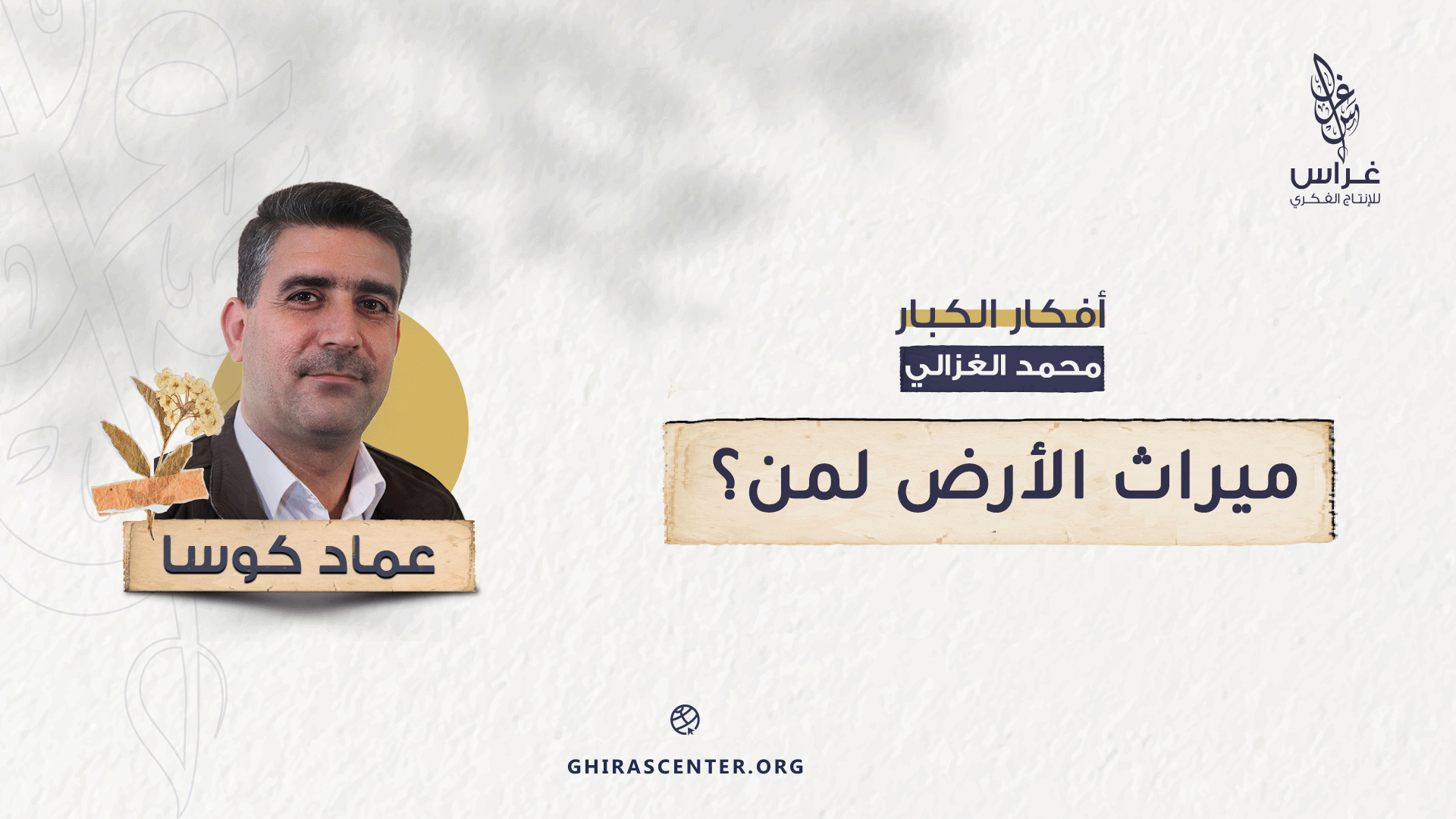
ميراث الارض لمن؟
كانت النزاعات التاريخية بين الامبراطوريات قائمة على السيطرة والتمدّد ووراثة الأرض بمواردها، فتعاقبت الكثير من الحضارات التي امتلكت أسباب القوة لترث بقعة من الأرض، ثم تلاشت مكانتها مع تلاشي تلك الأسباب، برهانًا على سنن التغيير والتدافع والاستبدال، فهل كانت كل تلك الحضارات جديرة بميراث الأرض؟ وما هو نصيب الأخيار من هذا الميراث؟
سيطرت حضارات مادية بحتة ودامت لعهود طويلة على الأرض، وظهرت أخرى جمعت مابين الجانب المادي والقيمي، وكلتاهما خلّفتا في الذاكرة البشرية انطباعها المحسوس، وهذا الانطباع يسهم في نسج المخيال حول الحضارة الأصلح لحياة الإنسان على الأرض، الحضارة التي تعمر الأرض بقيم الصلاح، لتفوز بأرض الجنة في نهاية المطاف. لقد وعد الله تعالى الصالحين من عباده أن يرثوا الأرض ﴿ولقد كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ من بعد الذِّكْرِ أَنَّ الأرض يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾[1]
فما هي حقيقة هذه الأرض؟ يغوص بنا الغزالي عميقًا في كتابه (الغزو الثقافي يمتدُّ في فراغنا) لندرك معنى الميراث، ومعنى الأرض التي يرثها الصالحون، وعناصر الصلاح التي ارتبط بها الوعد الإلهي، وكيف يمكن أن يتحقق اليوم.
يميّز الغزالي بين معنيين من معاني وراثة الأرض وهما:
المعنى الأول: الفوز بالجنة، حيث يدوم الصراع في هذه الدنيا بين الخير والشر ليفضي في النهاية إلى مصلحة المؤمنين الذين يفوزون بالجنة، ويتجلى ذلك في الآية الكريمة ﴿وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُۥ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ﴾[2]، والأرض التي يراها الغزالي هنا كما رآها الكثير من المفسرين ومنهم سيد قطب هي أرض الجنة، وهي الأرض التي تستحق أن تورث. فيهنأ بها المؤمنون وقد صدقهم الله وعده، فيسكنون فيها حيث شاءوا وينالون منها ما يريدون، في حين لم ينل الظالمون سوى الخزي والحسرة والندامة وأشدَّ العذاب. ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَٰلَيْتَنِى ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا﴾[3]، كما يتجلى هذا المعنى في الآية الكريمة من سورة الأنبياء﴿ولقد كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ من بعد الذِّكْرِ أَنَّ الأرض يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾.
في هذا السياق تفسّر هذه الآية أنّ الأرضَ هي أرضُ الجنة يرثها العباد العاملون بطاعة الله تعالى، المنتهون إلى أمره ونهيه، دون العاملين بمعصيته منهم، المؤثرين طاعةَ الشيطان على طاعته.
فالظالم الذي يتباهى بفوزه إذْ يقتل الناس الأبرياء، أو يسجنهم ويسومهم سوء العذاب وينكل بهم أشد تنكيل، سوف يبكي طويلًا، ويصلى سعيرًا. أما المظلوم المضطهد المحتسب الذي صبر على الويلات من ظلم وسجن وتنكيل في سبيل الله تعالى فسوف يفرح بفوزه إيّما فرح يوم القيامة. وشتان ما بين الفوزين.
وهذا المعنى من معاني وراثة الأرض يضع فكرة النصر في الميزان، فمن هم المنتصرون حقًا؟
وهذا المعنى يطَمْئنُ المؤمنين، فهم المنصورون في النهاية، فالنصر الحقيقي هو النصر يوم الدين، والفوز النهائي هو الفوز بالجنة والنجاة من النار، وهم يعلمون أنّ محكمة العدل الإلهية لا تقام في هذه الدنيا وإنّما في يوم القيامة. وهذا المعنى يتسع مع إدراك أنّ هذه الحياة هي دارُ ابتلاء واختبار للمؤمنين، وليست دارَ نعيم لهم.
وهذا المعنى من معاني وراثة الأرض يضع فكرة النصر في الميزان، فمن هم المنتصرون حقًا؟
إذا كنا قد أشرنا إلى النصر النهائي يوم القيامة وهو من حظ المؤمنين، فمن ينتصر في هذه الدنيا؟ هل انتصر المشركون في أحد؟ وهم يحاربون رسالة الله ويقتلون حملتها الذين خرجوا لتحرير الإنسان من عبادة الأوثان، وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد. وهل الذي انتصر كان على حق؟ وهل كان لنصره معنى؟
وفي قصة أصحاب الأخدود هل انتصر الكفار وهم يلقون بالمؤمنين في الأخدود ويحرقونهم ويبيدونهم عن بكرة أبيهم؟ وهل خاب المؤمنون وهزموا شرّ هزيمة حين أبيدوا؟
وفي قصص نعيشها اليوم هل انتصر الظالم على أطفال غزة وسوريا واليمن والروهينغا والإيغور…؟ وما طعم هذا النصر؟
المعنى الثاني: الفوز بالأرض، فحملةُ العقائد هم من ينتصرون ويرثون الأرض والسيادة في الدنيا قبل الآخرة (إن الأرض يرثها عبادي الصالحون) فالأرض في هذه الآية يراها الغزالي بمعناها الدنيوي في عالم الشهادة، والنصر هنا هو رفع راية الإسلام على البقعة الجغرافية والحكم بما أنزل الله تعالى فيها. ولا يحصل ذلك إلا حين يبلغ حملة العقائد مستوى معينًا من الكمال الشخصي والرقي الاجتماعي والقدرة على إسداء الخير العام. ونموذج الصحابة والتابعين خير مثال على ذلك. ثم توالت أمثلة متفرقة على هذا النصر في التاريخ الإسلامي. ويستفيض الغزالي في شرح هذا المعنى معرجًا على عناصر الصلاح وأسباب النصر، ومبينًا في الوقت ذاته داعيات الهزيمة المستمرة.
أسباب تراجع الأمة أمام خصومها
يذكر الغزالي في كتابه (الغزو الثقافي يمتد في فراغنا) جملةً من الأسباب التي كانت وراء تردّي أحوال الأمة وتراجعها الحضاري، وتخلّيها عن دورها الرسالي، كما يلي:
- الخلل الكبير في سياسة الحكم والمال.
- غلبة التقاليد القبلية.. القومية
- الفجوة بين علوم الكلام والفقه من جهة وعلوم التربية والسلوك من جهة أخرى.
- اختفاء القضايا الحيوية المهمة وبروز قضايا هامشية تافهة.
- ضعف المستويين الفكري والاجتماعي لدى أعداد من المتحدثين الإسلاميين.
ولعلَّ هذه الأسباب مقسّمةٌ على جانبين أساسيين في أفكار الغزالي
أولًا- في الجانب المادي
فمن أسباب التقهقر الواضحة لدى الغزالي والتي رسّخت تبعية البلدان العربية وتخلفها هي انتكاستها في المجالات الحياتية المختلفة السياسية والزراعية والصناعية، فالتراجع العلمي خلّف جهلًا بالموارد المادية المتاحة وجهلًا في سبل استثمارها إن أدركتها. فهذه البلدان تملك الأرض الزراعية ولا تحسن زراعتها فلا تحقق اكتفاءها الغذائي الذاتي، بل تقوم باستيراد ما يمكن أن تنتجه. وتملك الخام ولا تحسن استثماره وتحويله عبر الصناعات التحويلية البسيطة. وتملك ثروات طائلة لا تحسن إدارتها وتحويلها إلى أوراق قوة تصعد بها إلى مصاف الأقوياء، وترث الأرض.
وإنْ كانت هذه الأسباب جليّة لا يمكن التغاضي عنها فإن للحقيقة وجهًا آخر نستشفه من كتابين شهيرين، أحدهما للكاتب الفرنسي معتنق الإسلام روجيه غارودي (Roger Garaudy) في كتابه (حفارو القبور- الحضارة التي تحفر للإنسانية قبرها) حيث يبرهن غارودي أنه ليس العرب وحدهم من يعاني من هذه التبعية، وإنما هي تبعية مفروضة بأشكال مختلفة من قبل الدول الاستعمارية على أغلب البلدان غير الاستعمارية. حيث تحرص الدول الاستعمارية على إبقاء باقي العالم تابعًا لها من خلال تدمير مواردها الحيوية وعدم تمكينها من استغلالها بشتى الوسائل. الهند مثالًا.
والكتاب الآخر لعالم الاقتصاد والكاتب والناشط السياسي الأمريكي جون بيركنز(John Perkins) في كتابه (الاغتيال الاقتصادي للأمم) الذي هو بمثابة سيرة ذاتية لنشاطه كأحد قراصنة الاقتصاد يوضح فيه كيف نجح قراصنة الاقتصاد في تحقيق سياسة التبعية على البلدان النامية عبر أشهر مؤسستين عالميتين (صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية) حيث قدمت القروض بسخاء للكثير من البلدان، بل تم إغراقها بالديون لتبقى ذليلة وتابعة. والغريب أن تلك القروض لم تحسن من أحوالها، بل زاد فيها الفقر، وانخفض مستوى التعليم والصحة. لقد ازدادت أوضاعها سوءًا. وهذا ماكان يبتغيه أولئك القراصنة.
ثانيًا- في الجانب الديني
يرى الغزالي أنّ أهم أسباب تراجع الأمة أمام خصومها يكمن في التدين الأبله الذي يهدف إلى إفساد الصحوة الإسلامية، فهو يسأل أسئلته الواضحة:
- أكنا أهلًا للنصر والبقاء في الساحة العالمية؟
- أكنا أصحاب رسالة سليمة؟
- أكنا على المستويين المادي والأدبي لخدمة الحق؟
- أكنا نموذجًا صالحًا للإسلام تهفو إليه الأفئدة وتتطلع إليه الأبصار؟
ويجيب بهدوء وثقة: لا لم نكن.
لم تكن سياسة الحكم والمال في البلاد الإسلامية لتمكنهم من النصر. ولم تكن العلاقات الاجتماعية على مستوى حمل الرسالة، ولم تكن الثقافة الإسلامية هي السائدة في هذه البلدان، في حين شاعت الخرافات والأوهام التي نالت من العقائد والأخلاق.
والسؤال هنا، متى طُرد المسلمون من مراكز القيادة أول مرة؟ وهل كانت الدول الإسلامية القائمة إبان بزوغ شمس المدنية الغربية تحمل الرسالة الإسلامية الخالدة، وكانت نموذجًا يحتذى؟ وهل كانت وارثة أم موروثة؟
ويرى الغزالي أنّ طردَ المسلمين من مراكز القيادة العالمية لم يكن ظلمًا نزل بهم، بل كان العدلُ الإلهي نتيجة تركهم الرسالة مصداقًا لمعنى الآية الكريمة ﴿ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍۢ لِّلْعَبِيدِ﴾[4]
والسؤال هنا، متى طُرد المسلمون من مراكز القيادة أول مرة؟ وهل كانت الدول الإسلامية القائمة إبان بزوغ شمس المدنية الغربية تحمل الرسالة الإسلامية الخالدة، وكانت نموذجًا يحتذى؟ وهل كانت وارثة أم موروثة؟ وللإجابة عن ذلك لا بدّ من دراسة التاريخ الإسلامي أو تاريخ الدول الإسلامية وفقه هذا التاريخ، لإدراك عدة مسائل، منها أنّ سراج الإسلام ظلَّ مضيئًا على الأرض، فما كان يخبو نوره في بقعة جغرافية إلا ليتوهج في أخرى، ومنها أن انطفاء السراج في بقعة ما كان إشارة على نقصان الزيت فيها، مترافقًا مع هبوب الرياح الهوج التي لم تهدأ قط. وتوهّجه في بقعة أخرى دلالة على قوة كامنة تشكل باعثًا لا ينضب، وعلى همة متجدّدة لفئة تظل قائمة بالدعوة والصلاح على أديم الأرض.
وعلى مستوى الفرد أو الجماعة هل تبقى الأرض التي نملكها- نرثها- في الدنيا بين أيدينا أم يستبدلنا الله بسوء أعمالنا؟ وسنة الاستبدال تقع ضمن المنظومة السننيّة للتغيير التي تشمل أيضًا سُنَّة التدافع، وسُنَّة موت الأمم، وسُنَّة التمكين، وسُنَّة العلو والانحطاط وغيرها من السنن التي يمكن أن تقاس في تاريخ الأمم وتعرف بها مآلاتها.
فيحل الاستبدال عقوبةً لنا أو ابتلاء واختبارًا. فالأرض التي نرثها لها حقٌّ علينا في إعلاء كلمة الله تعالى فيها، والحكم بما أنزل الله تعالى. فإن تقاعسنا وركننا إلى أهوائنا ولهثنا خلف متاع الأرض، واستبدلنا شريعة أخرى بشريعة الله، فإن هذه الأرض سوف تلفظنا.
فالنعمة لا تزول والأمة لا تندثر إلا بمقدمات مادية ومعنوية مضبوطة بقواعد حركة التغيير الكبرى في حياة الأمم.
﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾
﴿إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا﴾[5]
﴿هَٰٓأَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ، وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم﴾[6]
فالنعمة لا تزول والأمة لا تندثر إلا بمقدمات مادية ومعنوية مضبوطة بقواعد حركة التغيير الكبرى في حياة الأمم.
﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾[7].
هل الحضارة الغربية هي من ورثت الأرض؟
لا ينكر الغزالي أنّ الحضارة الغربية أحرزت تقدمًا ونهوضًا براقًا جعلها في موقع القيادة العالمية، لكنه يسأل فيما إذا كان هذا التألق المدني قد خدم البشرية؟ وهل كانت هذه الحضارة أحقّ منا بالقيادة؟
«الحضارة الحديثة بشقيها الغربي والشرقي أحرزت تقدمًا هائلًا خدمت به أغراضها الرديئة. ولكي نكون أحقّ منها بالقيادة والسيادة يجب علينا أن نحرز تقدمًا علميًا أوسع من تقدمها، ولا يكفي هذا، بل يجب أن نضم إلى هذا الـتـقــدم العلمي تقدمًا خلقيًا يجعل تفوقنا الحضاري فى خدمة مبادئنا ومثلنا العليا. إن الأوربيين أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما أثرناها نحن وعمرناها، وقدروا على استخراج معادنها الجامدة والسائلة على حين عجزنا نحن كل العجز.
أفلا يزين لهم هذا السبق أنهم أولى بالأرض منا؟ وأنّ مبادئهم أحقُّ بالبقاء من مبادئنا؟ وأنّ أرباح هذا السبق حلّ لهم وحرام علينا؟»
ويشير الغزالي إلى قصور النظر حين يكون من زاوية واحدة، فلكي ننصف يجب أن نرى الأوضاع من الزاوية الأخرى، فإن كانت الأوضاع في الحضارة الغربية الحديثة برّاقة من الخارج تجذب الأنظار وتبهر النفوس، فهل مضمونها المعنوي من القيم والعلاقات الاجتماعية براقة أيضًا؟ وهل نالت هذه الحضارة الرضا وحازت على القبول وفازت بالبقاء؟
يوضح الغزالي أنّ الحضارة الغربية تمكنت من أسباب القوة المادية، لكنها لم تستحوذ على الأسباب الداعية للبقاء، فهي مجوّفة من الداخل، تُفقد الإنسان قيمته وتحوله إلى آلة وسلعة، إلى كلب يلهث دون توقف.
والأمة الوارثة يجب أن تكون مثالًا يُحتذى، بجميع جوانبها المادية والمعنوية، فالأمة الوارثة هي الأمة الصالحة التي تخدم البشرية في ساحة التطور العلمي وتخدمه في ساحة الرقي الاجتماعي والخلقي. وحتى تكون صالحة عليها أن تمتلك عناصر هذا الصلاح.
عناصر الصلاح
لقد ذكر الغزالي معنيين من معاني وراثة الأرض، وكلا المعنيين لا يتحققان إلا بالصلاح سواء كان وراثة أرض الجنة أو وراثة الأرض في عالم الشهادة والسيادة فيها، ويحدد الغزالي لهذا الصلاح عناصرَ تجمع الاكتمال النفسي والصناعي والسياسي.
«الإنسانُ الصالح ليس صاحبَ العقل الكبير فحسب، بل ينبغي أن يكون كذلك صاحبَ قلبٍ سليم وضمير يقظان وقدرة على كبح نفسه وامتلاك رغبته»
«إنّ حملة العقائد الجديرين بالنصر ليسوا قطاع طريق ورجال عصابات، إنهم طلائع المعرفة وأشعة اليقين وأصحاب الأخلاق الزكية والأنفاس الطاهرة، إنهم صانعو النهضات الحقيقية، وأخلاق النبيين التقاة، وقادة الفكر الواعي والسلوك المجدي»
ومعنى الصلاح عند الغزالي أوسع من عبادات تقليدية، إنه عالم رحب الآفاق بكل شيء في مقدور البشر، من تنظيم نظافة الوجوه والثياب والبيوت والشوارع والقرى والمدن، إلى أمان ضد الجوع والقلق، إلى كفالة لحرية العقل والضمير تنمو فيها المواهب وتنضج الملكات وتكتمل الشخصية وتصان المرافق العامة والخاصة، وذلك يعني إصلاحًا في محورين أساسيين هما:
- إصلاح الجانب المادي بأن توفر الأمة الإسلامية غذاءها وتصنع سلاحها بنفسها. فقد انهزم المسلمون في أحد لأنهم تجاهلوا أسباب النصر المادية، ولم يكن المشركون أولى بالنصر منهم، لكن السنن الكونية لا تحابي حتى جيل الرسالة.
- إصلاح الجانب الديني فلا نهضة مع الجهل والانصراف عن العلم إلى الأوهام. وهذا الجانب يلزمه دعاة ومفكرون ورجال نهضة وتمكين يتبعون سبل سليمة للدعوة، مشيرًا إلى السبل التي يتبعها رجال الكنيسة في حملاتهم التبشيرية حيث يستخدمون كل وسائل التأثير والجذب بما فيها الإنتاج الأدبي والفني.
ولا مناص أمام الأمة من فرز نخبها ودعاتها ليقوموا بالتغيير وهم من أمة جاء فيها حكم الله تعالى أنها خير أمة أخرجت للناس، خير الناس للناس بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وإيمانها بالله تعالى.
﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾[8]
وأخيرًا لمن ميراث الأرض؟
إنّ الأرضَ الجديرةَ بالميراث لا تكون إلا للصالحين، والصراعُ في سبيل هذا الميراث بين الحق والباطل صراعٌ طويل الأمد، والحرب سجال، لكن آثار النصر تتفاوت، فحين ينتصر الحق تعمُّ النعم على جميع الناس، وحين ينتصر الشر تنعم الفئة الطاغية بطغيانها. ولكن الوعد الإلهي ماثلٌ أمامنا (ولقد كتبنا في الزبور أنّ الأرض يرثها عبادي الصالحون) والصلاح له مقتضياته وشروطه، مادية ومعنوية، تجتمع في بوتقة واحدة وتصنع النهضة. تذوي حضارة جماعة إسلامية في مكانٍ وزمانٍ ما، لتزهر أخرى في مكانٍ وزمانٍ آخر، وهكذا هي سنة الاستبدال والتدافع إلى يوم الحساب، يوم يفرح المؤمنون بنصرهم﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾[9]
[1] سورة الأنبياء (105)
[2] سورة الزمر(74)
[3] الفرقان (27)
[4] سورة آل عمران (182)
[5] سورة التوبة (39)
[6] سورة محمد (38)
[7] سورة الأنفال (53)
[9] يونس (58)



