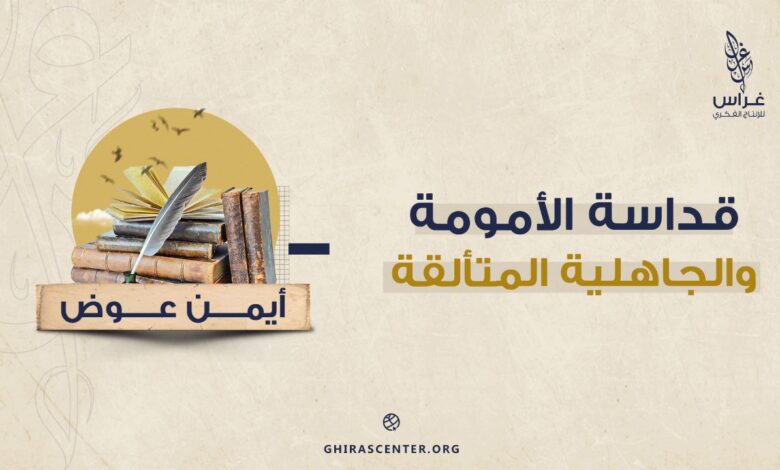
قداسة الأمومة والجاهلية المتألقة
الاستبضاع…لطالما كان التفاعل الشعوري بيني وبين هذا المصطلح يشبه تفاعلي مع إعلانات مساحيق التجميل أو بودرة الأطفال.. لا يعني لي أيّ شيءٍ على الإطلاق، وكان فرعون الحداثة الصغير الذي في داخلي يحدثني متذمراً، إلى متى سيظل علماء السيرة والفقه يذكرون هذا المصطلح ويشرحونه في كتبهم الصفراء!، ألم نطوِ صفحة تلك الأيام منذ زمنٍ بعيد!
والاستبضاع ببساطة، هو أن يرسل الزوج امرأته لتجامع رجلاً من كرام القوم فتنتقل الصفات الحسنة والأخلاق الحميدة للطفل الذي في بطنها، هذا في جاهلية أبي جهل، أما في جاهلية اليوم فهو أن يقوم رجلٌ بالتبرع بالنطاف إلى أحد النساء بحيث يتم الحمل دون زوج، وبذلك تتمكن النساء اللواتي يدعمن الحركات الكارهة للزواج والساعية للتحرر من سلطة الذكور من أن يصرْنَ أمهاتٍ بلا بعول، هذه الجاهلية المتألقة التي تقف ورائها بعض الحركات النسوية من جُرف، وشركات الدواء والعلاج من جرفٍ آخر يشعلان عندي رغبةً عارمةً للترحُّم على أيام أبي لهبٍ وعقبة بن أبي معيط.
التبرع بالنطاف وتأجير الأرحام والاستبضاع، والنظر إلى الزواج والأمومة وتربية الأولاد على أنها قيودٌ في طريق تحقيق الذات، والنداءات المتهالكة لتشريع حق الإجهاض، كل هذه أمورٌ قديمةٌ في ميدان الترندات، ولكن ما دفعني لإثارة غبارها هو مقطع الفيديو الذي رأيته في الفترة الأخيرة.
حيث ظهرت الخمسينية المتصابية تشيلسي هاندلر في برنامج long story short، لتعرض وجهة نظرها في عدم إنجاب الأطفال فاستهلَّت حديثها بالكلام عن بشاعة الأطفال، وكمية الإزعاج التي يصدرونها للعالم من حولهم، ولا أخفي إعجابي بهذا الكلام.
ثم عززت تشيلسي وجهة نظرها باستعراضٍ مبهرٍ لنمط حياتها المفعم باللذةِ والمتعة والعيش الحر بعيدأ عن قيود الأسرة والأطفال، فبدون أطفال من السهل عليها أن تصعد قمم الجبال وتغوص أعماق المحيطات، وكأننا ما جئنا إلى الدنيا إلا لإنجاز بعض هذه الرحلات الممتعة، ولكنني أقبلُ هذا منها أيضأً، باعتبارنا نعيش في حضارةٍ لاتُها الفردانية وعُزَّتُها الليبرالية.
وحدي ولو ذهب الأنام جميعهم
وإذا هلكت فدوني الطوفان
ثم عرضتْ شيئاً من الآثار السلبية للحمل والولادة والآلام المصاحبة لكلٍ منهما، وختمت حديثها بمقطعٍ تمثيليٍّ ساخرٍ مع طبيبةٍ تحدثُها عن فوائد عدم الإنجاب وميزاته للأنثى -وخاصةً الجمالية منها- بأسلوبٍ وقحٍ وبعرضٍ مُضللٍ مستغلةً مشاعر الجمهور لينتهي المقطع بتصفيقٍ صاخبٍ وانتصارٍ وهميٍ.
فكما أنه لا ينكر أحدٌ أن الحمل والولادة -وخاصةً إن كان بكثرة- يؤثر على صحة المرأة ويعرضها للعديد من المخاطر والأمراض، إلا أن العكس غير صحيحٍ تماماً، إذ أن الكثير من الدراسات العلمية تتمحور حول العلاقة بين سرطاني الثدي وعنق الرحم والإرضاع وعدم الإنجاب على التوالي
لقد صدف أنني رأيت المقطع في الأيام التي كنت أتلقى فيها التدريب الطبي في قسم النسائية والتوليد في المشفى، وكنت حديث عهدٍ بمعلوماته النظرية، فكما أنه لا ينكر أحدٌ أن الحمل والولادة -وخاصةً إن كان بكثرة- يؤثر على صحة المرأة ويعرضها للعديد من المخاطر والأمراض، إلا أن العكس غير صحيحٍ تماماً، إذ أن الكثير من الدراسات العلمية تتمحور حول العلاقة بين سرطاني الثدي وعنق الرحم والإرضاع وعدم الإنجاب على التوالي، إذ يُعدُّ الحملُ والولادة من العوامل الرئيسية التي تحدُّ من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم1 وكذلك فإن عملية والولادة والإرضاع الطبيعي هي من العوامل التي تحمي الأمّ من سرطان الثدي2، وعلى نقيض ذلك يعدٌّ عدم الإنجاب من عوامل الخطورة الأساسية في كلا السرطانين، حتى إن الحمل بحد ذاته قد يرتبط بتخفيف حدة الأعراض في الأمراض المناعية، وما ذكرت من معلومات طبية هي على سبيل ضرب المثال لا على سبيل الإحاطة والحصر، والهدف منها الذود عن حياض رحم الأمومة لا أكثر، وإلا فالكلام يطول في هذا المقام.
أتألم حينما أرى مرتبة الأمومة تُنتهكُ قداستُها وتتحول إلى أمرٍ عاديٍّ، بل ومهينٍ في بعض الأحيان، حتى بات يتولّدُ عند بعض الإناث رهابٌ من الكلمة بحد ذاتها، واستياءٌ من تلك المهمة الفطرية السامية، وما ذاك إلا لأن الأمر بات ينظر إليه من زاوية المصلحة الدنيوية الآنية، والراحة المؤقتة والسعي لاستدامة النضرة والشباب، ولكن -ويا أسفاه- فالشباب يفنى سواء بزاوجٍ أو بدونه، وسيان في ذلك الرجال والنساء، ثم إن الشارع الحكيم الذي خلق الولادة وما فيها من متاعب وآلام وجعلها من مهمة المرأة،كافأ تلك الأنثى بمجرَّد أن قبلت التكليف وصارت أماً أن جعل الجنة تحت قدميها، وخدمتها مقدمةً على جهاد الطلب في بعض الظروف، وجعل رضاها من رضا الرحمن وبرَّها مقدمأً على بر الآباء.
وأما بالنسبة للمكاسب الدنيوية، فإضافةً لما سبق من فوائد طبيةٍ محتملة، واستقرارٍ نفسيٍّ منتظرٍ بتحقق الذات في الأمومة، فلا يخفى على أحدٍ ذلك الدفء الذي تنعم به الأمهات عند الكِبَر في الأسرِ الصحية سواءً في مجتمعنا أو غيره من المجتمعات، ومما يدعم هذه الرؤية ما ذكرته الكاتبة هدى عبد الرحمن النمر في بحثٍ تفصيليٍ يعرض مخاطر وسلبيات قرار تأخير الزواج والإنجاب وفقاً للدراسات والأبحاث حيث تقول في خاتمته:
“وأما فورة تحقيق الذات فلا تقوم أصلاً في امرأةٍ أدركت خطر دورها في ربابة البيت على ما سبق بيانه، فقامت بحقه إيماناً واحتساباً لما تنفقه من عمرها وطاقاتها فضلاً عما تحظى به من كفاية ماليةٍ وارتواءٍ فيزيائيٍ ومعنويٍ، بذوق مختلف الخبرات الزوجية والوالدية، ثم إذا شاءت بعد كل هذا الاستزادة فمجالات الشغل المأجور والتطوعي والمهني والإبداعي والتعلم الذاتي لمختلف أنواع المهارات كثيرةٌ مفتّحةُ الآفاق ولا تستلزم شد الرحال أو شهادةً جامعية بالضرورة، بل المطلوب فحسب إتقان مهارةٍ ما بالدرجة التي تتولد عنها طاقة إنتاجٍ معتبر ذي جودة وكفاءة بالمجال”3



